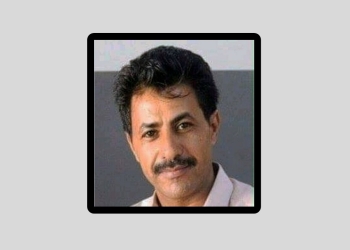في تكريم قارئ يٌدعى جلال الرداعي




- كتب: ريان الشيباني
من هو جلال الرداعي؟ لا تستغرب إذا قلت لك إنني لا أعرفه، لكن وأنا أخاطبه كشخص، أُكَّرمهُ في سياق الوضع اليمني كظاهرة. كنت يوم الأحد قبل الماضي في جولة بمنطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء، عندما عَرَّجت مع صديقين آخرين على بسطات الكتب في الرصيف الفسيح المحاذي للشارع الرئيس شرقًا، وهناك أثارت اهتمامي مجموعة جديدة من الكتب معروضة لدى أحد الباعة. كانت تبدو على نحو من الجِدّة، نوعية وأصلية ولا تحمل أي معالم استنساخ، ومُسعَّرة على غلافها الخارجي بأسعار بين 2000 و3000 ريال (الدولار يساوي 530 ريالًا يمنيًا قديمًا)، وبما يعتقد بائعها الأصلي أنه يوازي قيمة محتواها.
فطنتُ بخبرتي في فحص أرصفة الكتب، بأنها لمالك واحد، فحاولت الذهاب نحو استدلال دامغ، يؤكد فرضيتي، بتقليب الصفحات الأولى منها. ونعم، كان على معظمها ختمًا أزرقًا مستطيلًا، يحمل اسم جلال الرداعي، وآخر أخضرًا أنيقًا يُمثّل أيقونة صينية على ما يبدو، ومكتوب أسفله عبارة بالحروف الصينية عند ترجمتها حملت اسم: قلعة تشينغ أو ما يسمى بمدينة الحصن الأخضر، ليبدو دلالته مبهمة وغير مفهومة. لكن الكتب تنتمي لمكتبة تبدو من الحميمية بمكان، ومقتناة- على مايبدو من عناوينها- بعناية، من قبل شخص مثقف إن لم يكن قارئًا نوعيًا؛ فمن يا ترى يكون جلال الرداعي هذا؟!
لستُ بوارد البحث عنه، وقد تحوّل إلى ظاهرة في سنوات اليمنيين العجاف، إلى درجة لم أعبأ فيها بكشف هويته وأنا أتناوله هنا. إن الحرص الذي أبداه هذا الرجل للإبقاء على اسمه بارزًا في مكتبته المُباعة، إذا لم يمثل تمسكًا معنويًا بهذا الإرث الثمين في أوقات التخلي القسري، فهو دليل إدانة لمرحلة تاريخية أهين فيها المثقف اليمني وباع أغلى ما يملك ليكسب قوت يومه. وأنا لا أخالف هذه الأغراض كثيرًا، بل أكثر من ذلك أسعى إلى نوع من التكريم لحق هذا القارئ غير الاعتيادي.
صديقي الذي رافقني في الزيارة الأولى لبسطة الكتب هذه، اقترح على البائع مبلغًا يوازي نصف سعرها، ما أثار سخط الأخير، وجعله يتمسّك بسعرها أكثر. باعتقادي أن وراء هذا التصلب للبائع تصلّب آخر لصاحب المكتبة المُباعة، والذي يعرف جيدًا قيمتها، إلى درجة أنه هو من وضع هذه الأسعار على أغلفتها، كي لا تقع في يد قارئ مُساوم. أمّا أنا فانشدهت بالعناوين عن أن أُنقّب وراء مالكها، وما يمثلهُ من قصة، بالضرورة ستكون ثرية وعلى جانب من الألم. لكن في الأيام التي تَلتْ مغادرتي لهذه الحكاية، شعرتُ باستغاثة تلك العناوين البرّاقة، وعذّبني هاجس بقائها في الرصيف، فأردتُ التطهّر بزيارة أخرى بعد ما يقارب الأسبوع.
عدتُ إلى بائع الكتب، ورجوت ألا يعرفني كزائر للمرة الثانية لبسطته، حتى لا أثير حفيظته في كوني لا أمتلك القدرة المالية للشراء، وللأسف كان الرجل على نفس المستوى من أدرنالين الطَفر. لقد كان يحاول طرد قارئ عجوز، بحجة أنه دأب طوال السنوات الأخيرة أذيته بتقليب الكتب دون شرائها. مرَّ العجوز، فتأكدت أن هذا الأمر لا يشملني كزائرٍ ثانٍ، وهو ما أتاح لي الفرصة لتقليب الكتب وتصوير جزء من محتواها، بخديعة أنني أصوّرها لصديقٍ مشترٍ.
كانت جزء من الكتب قد بيعت، لكن تبقت عناوين أخرى، ومنها: منطق ابن خلدون للدكتور علي الوردي، وطبعة أنيقة لكفاحي لأدولف هتلر، وتاريخ الفلسفة لإبراهيم الزيني، والفتنة لهشام جعيط، ومجموعة أعمال مخائيل نعيمة، والعقد الاجتماعي لجان جاك روسو، وابن رشد لعباس العقاد، ورواية تانغو الخراب للبوكر سلوكراسناهوركاي، ورواية بخور عدني لعلي المقري والكاتب والمنفى لعبدالرحمن منيف، وتاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد لطفي جمعة.
من العيش في السياق اليمني، تبدو الأسباب الكامنة وراء بيع اليمنيين لمكتباتهم معروفة، فإذا لم تمثل المعرفة بكينونتها المادية عبئًا على قارئ أو مثقف لم يعد يستطع تدبّر كلفة إيجار سكنه، فإنها تمثل موردًا للعيش في سنوات التخلي عن المقتنيات وبيعها. هذا إلى جانب أن هناك موجة ضاربة من الهجرة، بعد فقدان الأمل في تعافي اقتصادي منتظر، دفع بهذه الممتلكات الثقافية الثمينة إلى الرصيف، عوضًا عن حالة الشعور بالضيم واليأس، وسط سياسات ممنهجة لتهميش كل ما له صلة بالمعرفة والثقافة، والحط من قيمتهما.
قبل حوالي سنتين، عثرت على مكتبة شخصية مُباعة في بسطة كتب بشارع الزبيري، لكنها تعكس أكثر روح القنوط التي أصابت النخب الثقافية بمقتل. كان مالك المكتبة شابًا مثقفًا نخبويًا، تعرّفت عليه من اسمه على الكتب المعروضة في أكثر الشوارع حيويةً، ومن إهداءات المؤلفين له. لقد كان اسمه مدونًا بوضوح على صفحاتها الأولى. الشاب نفسه، كان قد تداول أصدقاؤه المقربون مغادرته للحياة العامة قبلها بأشهر، وتوجه- على ما يبدو- لهجر كل ما له صله بماضيه مع الكتب وأصدقائه المثقفين، ولا يزال متواريًا حتى هذه اللحظة.
ومثلما بدا لي من أن الردّاعي، سابق الذكر، تخلص من كتبه قد يكون لدواعي اقتصادية أو لاختياره طريق النزوح والهجرة، كان صديقنا الأخير بوضع مادي ميسور يعفيه من بيع كتبه، ما يعني حالة فريدة من الاحتجاج على القيم التي أفرزتها الحرب، ولم تستطع الثقافة معالجتها أو منعها. أيضًا هناك مجال لبناء مقاربة أخرى، فالرداعي الذي لم يبذل جهدًا لإخفاء اسمه من على صفحات كتبه، بدا كما لو أنه يريد أن يثبت ملكيته لها حتى وهي في عهدة قارئ آخر، بخلاف صديقنا الأخير الذي يبدو دافع تركه لبصمته على كتبه نفسيًا وتطهريّا.
وفي النهاية، يبدو أن هناك قاسمًا ضمنيًا مشتركًا، لإبقاء المالكين الأصليين للكتب لهويتهم عليها، يتجسّد في وصم الحضيض الذي نعيشه، وللتطهّر من سنوات التعويل على التراكم الثقافي لتخليص الأمة من عللها. ففي سنوات ما قبل الحرب، كان هناك نوع من الإدانة بحق الذين يتركون أسمائهم على الكتب التي يبيعونها، ولذا يلجأ الكثيرون لنزع الصفحات الأولى منها لإخفاء هوية ملكيتهم لها، أو لعدم تعريض من يهدونهم إياها للإهانة. أما اليوم، فالوضع مختلف، وقد رأينا مشهورين ونُخب يعرضون مكتباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إما رغبةً في توفير مصاريف طبابة، أو تعويضًا عن راتب شهري مُصَادر ومنهوب.
- الصور المرفقة خاصة بي.